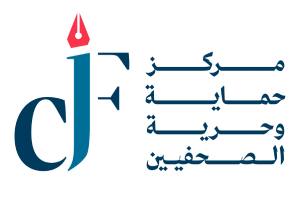الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان –
سام الغباري أول صحفي يمني يعتقله الحوثيون، وقد اطلق سراحه في إبريل من العام الجاري، بعد 63 يوما من الاعتقال.
ويكتب الغباري عن قصة اعتقاله في حلقات بعنوان “السجين رقم 851″، وقد حصلت صحيفة الجزيرة السعودية على حقوق نشر الحلقات.
– زنزانتي باردة وموحشة، أكتب إليكم من خلف القضبان، أنا مُختَطّفٌ بداخل السجن المركزي بمدينة ذمار، واليوم هو الثامن والعشرون، حيث سمحت لي إدارة السجن بالكتابة على الورق، ما زلت هنا بلا سبب!، والمظاهرات الحاشدة تهز شوارع مدينتي القريبة من العاصمة اليمنية «صنعاء» مطالبة بحريتي وإنهاء حكم ميليشيا الحوثيين الانقلابية!، قناة “المسيرة” التابعة لهم تُـصاب بالذعر، وتبث تقريراً مفبركاً يتهمني بالتزوير والاحتيال، كان الأمر أشبه بإعدام معنوي، لا استطيع الرد والدفاع عن نفسي، لم يحاكمني أحد!، قانون ابن بدر الدين الحوثي المُستبِد هو الأعلى، إنهم يعاقبون الصحفيين المناوئين لهم، وكنت أول صحفي تعرض للاختطاف والسجن والتعذيب والتشهير بسبب آرائي الرافضة لإعلانهم الدستوري القاتل للجمهورية، الأصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي يكررون مناشداتهم لتلك الجماعة المتمردة لإطلاق سراحي، أصدقائي يشيرون لي على صفحتي بفيس بوك عبارات تشجيع وتضامن، صرت نجماً محلياً مُـغيباً عن الأنظار، اتصل رفيقي «شاجع»: لقد أصبحت مشهوراً يا صاح!، التعاطف بلغ ذروته، الحوثيون مصرون على تدمير مستقبلي المهني بأي وسيلة، ومع نهاية كل أسبوع يسقط أملي في العبور إلى الحرية.. فماذا حدث؟! ولا أدري لماذا أريد أن أنقل إليكم كل هذه التفاصيل:
الحلقة الأولى
الاختطاف
– 9 فبراير 2015م – الساعة التاسعة صباحاً..
– ذهب أخي الأصغر لشراء بعض الجبن لتناول الفطور، وتركني في محل والدي الذي يُـباع فيه الأقمشة على الطريق العام بالمدينة، اقتحم عشرة مسلحين المحل، كانوا يرتدون ثياباً خضراء ومزركشة، بعضهم يضعون شعارات طائفية تدعو للموت على خزائن أسلحتهم الكلاشينكوف، شكلوا نصف دائرة وبنادقهم مصوبة إلى صدري!،كانوا مستنفرين بشدة، أصابعهم على الزناد، تحول المحل إلى ثكنة تمتلئ بالقتلة والأسلحة، وعلى الفور ضربني أحدهم بمؤخرة البندقية على صدري عِدة مرات، فسقطت على ظهري، وسحبوني إلى الخارج، أحاول الصراخ إلا أني لم أستطع، صدري يؤلمني بشدة، جسدي يرتجف، شعرت أن ضلوعي تنهار، استجمعت قواي وأتذكر أني قلت لهم خائفاً: ما الذي يحدث، اقترب أحدهم يصرخ: جاوب!
– من ؟.
– جاوب “أنصار الله” يا ابن الحرام!، وشدّني من ثيابي الثقيلة باتجاه سيارة هيونداي رمادية اللون نوع سنتافي يقودها شخص في العقد الرابع من العمر، قذف بي الحوثيون إلى الكرسي الأمامي، تحرك سائق السيارة التي تقلني بسرعة ترافقه سيارتين أخريين على ظهرها مسلحين ملثمين، قلت له: هذا اختطاف!، اندهش الصبية المراهقون الذين اقتحموا محلنا، وقد جلسوا في المقاعد الخلفية للسيارة “السنتافي” فيما توزع بعضهم على السيارتين اللتين تتبعاننا، وقال أحدهم بتعجرف: اسحب كلامك، هذه ليست أخلاقنا!، كنت خائفاً ومرعوباً، حاولت أن أبدو متماسكاً، لماذا تقتادونني بهذه الطريقة ؟! ابتسم سائق السيارة بهدوء: أنا “أبو سلمان”!، ثم رفع هاتفه الأسود الصغير واتصل “أيوه.. الخبير معنا”!. أغلق الهاتف، وأنا أكرر سؤالي : هذا اختطاف!، فقال : نحن الدولة، والدولة لا تختطف!، قلت: الشعب بـِرُمته يرفضكم، ويرفض إعلانكم الدستوري!، حاولت أن أتذرع بأي شيء للمطالبة بعودتي إلى المنزل لأنزع بيجامتي وأرتدي ثياباً رسمية!، ضحك كل من في السيارة، وقال أحدهم، “ولا عليك إلا نحمّمك في صعدة، أنت وسام الأحمر”!، التفت إليه وبادلته ابتسامة شاحبة.
– خلال دقائق معدودة ونحن في مبنى نادي “فتح” الرياضي، الذي استخدمه الحوثيون لإدارة عملياتهم الأمنية منذ احتلالهم للمحافظة قبل أربعة أشهر، ترجل الجميع، صعدت بلا حذاء على سلالم المبنى المكون من طابق واحد، أحدهم يحدثني غاضباً: أتعبتني وأنا انتظرك من أمس على باب بيتكم!.
-كان عليك أن تتصل بي وسأنزل إليك فوراً.. أجبته ساخراً.
-قبض على أصابعه كمن يتهيأ للكمي: كان البرد قارساً.
-أنا آسف..!، دلفت غرفة المبنى الواسعة التي خصصها الحوثيون للمقيل، وقد كانت صالة الألعاب الرئيسة للنادي، وجلست على مُتّكئأٍ : ها أنا ذا، ما الذي يجري ؟، قال شخص رائحته نتنة كبيت مهجور يتبول فيه المارة: ولا شيء قلنا بس نضيّفك عندنا!، كنا وحيدين في الغرفة، ظهر شخص ثالث من الباب ينادي بأعلى صوته «أين ابن الحرام» وكررها ثلاثاً! وصاح وهو يتقدم نحوي “يا غرباني خرّج هذا الصعلوك”، وكان يدفعني بقوة إلى غرفة مجاورة، والتفتّ إلى “الغرباني” قائلاً «هل هكذا تكون الضيافة» ؟ فقهقه ضاحكاً، ولم يعلق، ضربني الحارس في صدري بقوة، قال وهو ينظر إلى عيني مباشرة «أنت شيخ وإلا شيخة»!، أجبته بهدوء «مواطن فقط!»، «طالما وأنت مواطن، ليش تتكلم على السيد يا طرطور!»، لم أجبه، تمتمت فقط!
– إيش ؟!
– ولاشي ؟
– ايش تقول، ارفع صوتك ؟، أين التليفون ؟
– في البيت!
– إيش.
– في البيت!
– ارفع صوتك، ويقرب إذنه من وجهي، ويصرخ «ارفع صوتك، وإلا ما ترفعه إلا على المسيرة القرآنية»!، يغلق الرجل باب الغرفة التي تستخدم لإخفاء المعارضين!، تذكرت أني لم أتناول فطوري، شعرت بالجوع والخوف معاً!.
-لا أعرف ماذا يدور في الخارج، مرت الساعات دون أن أجد كِـسرة خبز، كنت أطرق الباب جوعاً، أزعجهم وأنادي: لماذا تعتقلونني ؟، لم أسمع شيئاً، كان المبنى خالياً من الحركة، بعد ساعات فتح شاب قصير القامة الباب في نزق: ماذا تريد؟
– أنا جائع!.
– انتظر الغداء!
– ممكن تقل لي لماذا هذا الحبس؟
– لما يجي سيدي بيكلمك ؟!
– سيدك من؟
– حيدر!
عرفت «حيدر» صبياً في العشرينات، اسمه الحقيقي «عبدالإله الديلمي» من إحدى قرى آنس بمحافظة ذمار، نحيل، حاد النظرات وفي عينيه لؤم تاريخي، أنفه معقوف كيهودي سابق، فنافقه الكثير، مثلاً، مدير قسم الشرطة العام بمدينتنا واسمه «عبدالملك السعيدي» يخطب وده ويتملقه لقاء بقائه في منصبه الذليل، رغم أنه برتبة مقدم في الأمن العام!، إلا أنه صار جندياً طائعاً بما يأمره ذلك الصبي «الطارئ» الذي سجن أبي، وأقفل دكان معيشتنا الوحيد لأكثر من شهر متذرعاً بخلاف بسيط نشب بين والدي وأحد مستوردي الأقمشة، وكان شرطه مقابل الإفراج عن والدي، وكفّ أذاه عنـّا: الاعتذار!، قال إنه من الرفعة تقديم اعتذاري العلني المكتوب لجماعته «أنصار الله» على كتاباتي في بعض الصحف والمواقع، ورفضت يومها وأتذكر أني قلت له بعناد: لن أعتذر ولو قطعتموني إرباً، ونهضت مغاضباً، فلحقني والدي إلى باب الغرفة وانحنى يهم تقبيل ركبتي، ويرجوني أن اخضع لهم، فمصيره مرتبط بما سأقوله أنا، قبضت رأس والدي وقبلته، رأيتهم يبتسمون في سخرية، وتمنيت لو أنهم قتلوني، شعرت بضعف والدي وإنكساره وهو في عُـمره العجوز ينظر إلى عينيّ متوسلاً، وأنا أنزف دماً في داخلي وقهراً لا يعوضه ألف أسف، وافقت على الاعتذار بشرط إخلاء سبيل والدي فوراً!.
– تدخل الرئيس السابق «علي عبدالله صالح» في الأمر، اتصل بي بعد أن تناقلت الكثير من الصحف ما فعله الحوثيون بوالدي، كان صوته حاداً: ماذا حدث؟!
– أهلاً يا فندم، الحوثيون أغلقوا دكان ألبستنا الجاهزة، واقتادوا والدي الذي يعاني أمراض القلب بلا مبرر إلى السجن، على خلفية قضية تجارية كانت النيابة العامة قد حكمت فيها لصالحنا!، فتذرع بها الحوثيون وطالبوا باعتذاري عما أكتبه عنهم!
– قل لهم عاد احنا بنكتب ألف مقال!، واستطرد : أين المحافظ؟
– اتصلت به وقال إن الأمر ليس بيده!
-كيف ليس بيده ؟! هو المحافظ، يحافظ على حقوق الناس وممتلكاتهم!
– اتصلوا به!
– خير!
ثم أغلق سماعته، وبعد ساعات اتصل بي نائب المحافظ، ثم لم يفعل أحدٌ شيئاً، ذهبت إلى النيابة، توسلت بكل المسؤولين الذين أعرف! لم يخرج والدي من السجن إلا بالتزام خطي بالاعتذار لهم!
– «حيدر» أحد الصبية الذين جاؤوا إلى مدينة «ذمار» لتولي مهام الجهاز الأمني التابع لجماعة «أنصار الله» الحوثية وفق اتفاق السلم والشراكة الموقع مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء يوم الحادي والعشرين من سبتمبر 2014م، عقب دخول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء وسيطرتهم على قيادة الفرقة الأولى مدرع التابعة للجنرال علي محسن الأحمر، رضخ جميع المسؤولين والقادة الأمنيين وحتى رئاسة الدولة، وهرب الجنرال (محسن) إلى مدينة «جدة» السعودية، يومها اطلق الرئيس السابق «علي عبدالله صالح» تنبيهاً بأن «على الذين يعتقدون أنهم سيُـخرجونه من بلاده كما خرج «علي محسن» فهم واهمون»!، كانت رسالته واضحة إلى الرئيس «هادي» لا تقترب مني.. فتخسر!.
– خسر هادي فعلاً، وطوقه رئيسه السابق بجنود موالين له أتوه من كل فج عميق، خلعوا بزاتهم العسكرية، وارتدوا ملابس مدنية، وحاصروا الرئيس في منزله، واعتدوا عليه بالضرب، تحول الجيش إلى أداة غير شرعية بيد الزعيم الجديد، يجوب أرجاء البلاد، ويستولي على مؤسسات الدولة باسم «أنصار الله – الحوثيين»، ويحاصر الحكومة التي لم تكمل شهرها الأول، ويُطلق الرصاص على رئيسها ، ويطوق الشوارع بالمدرعات والمصفحات المهيبة، قال لي الرئيس «هادي» في الرياض أنه اتصل للواء «علي الجائفي» قائد قوات الاحتياط يبلغه أنه محاصر!، أجابه الجائفي ساخراً: محاصر مِمن، انهم عيالك!، هل هناك قوة أجنبية تحاصرك!، أدرك «هادي» أنه لم يعد قادراً على فِـعل شيء وهو الرئيس الشرعي! فآثر تقديم استقالته على الرضوخ لشروط الميليشيا بتعيين نائب له، ثم فر إلى عدن بعد عشرين يوماً متراجعاً عن استقالته، وبعد هزيمته الثانية، غادر مسرعاً إلى عُـمان ثم السعودية حيث استقر هناك لقيادة تحالفه مع دول الخليج العربي لردع الانقلابيين وتدمير قدراتهم العسكرية.
– شاهد والدي ما حل بالرئيس، قال لي: يا بني لقد سقطت الدولة، ولن أصمد!، شعرت بالألم والغضب، رافقته من بوابة السجن إلى منزلنا، كان الناس مشدوهين وغاضبين، خائفين من المستقبل المسلح الذي ترسمه أفواه البنادق!، تذكرت كل ذلك وأنا محاط بأربعة جدران تلتهمني في شره صموت، كانت القبضة الحوثية قاسية وظالمة، لكني قررت أن أصمد في وجوه من لا أعرف أسماءهم!، أيقنت أن هذا اليوم لن يكون الأخير!، وقد اتعرض للمزيد من الضرب والتعذيب، وعليّ الاستعداد لأيديهم وأصفادهم.
– كان «أبو مراد» وهو شاب قصير القامة، لحيته مبعثرة على وجهه، ورأسه مدور ككرة قدم، يدخل إلى زنزانتي حاملاً الكثير من ملازم مؤسس الحركة الحوثية الراحل حسين بدر الدين الحوثي، تلك الملازم الورقية تمثل الرؤية الفكرية والجهادية للحركة الإرهابية، اعطاني منها ثلاثاً، واقترب حتى شعرت بأنفاسه : هذه ملازم الإيمان، الروح، غذاء القلب!، اشحت بوجهي عنه، ابتسمت وقلت ساخراً: نريد غذاء المعدة أولاً!، لوح بيديه في الهواء وقال: هكذا أنتم ماديون لا تهتمون إلا ببطونكم، قم صل ياخبير!
– عفواً أنتم اختطفتم شخصا كافرا.. أجبته.
– اتق الله!
– إيش اتقي الله، وأنتو تخطفوني من أمام منزلي وتسجنوني هكذا، وتقل لي قم صل!
– أنت صدمت اثنين أشخاص بسيارتك.. وهربت!
– قهقهت عالياً: أين هم نعالجهم، لا يموتوا!
اقتحم الباب طفل لا يتجاوز العاشرة يُـكنى «أبوعادل»: أخذ بعض الأحذية القديمة من زاوية السجن و جُـعل يقذفني بها ويشتمني بقبح فاجر، وأنا جالسٌ في مكاني أحاول تفادي أحذيته!، أرادوا أن أضرب ذلك الطفل لينالوا مني!، ثم خرج الاثنان من الغرفة وأغلقا الباب، أخذني النشيج، وقد انكمشت، شعرت بالإهانة والذل، وبأني وحيد في مواجهة آلة بوليسية إرهابية قمعية، بعد دقائق دخل شخص آخر ونحيل أمسكني من عنقي وجرني إلى الحمام المجاور، حاولت مقاومته، ودفعني بقوة حتى كدت أتعثر وأسقط، فهدد بحزم، وأقسم أن أي محاولة مني سيكسر عظامي ولن ينفعني أحد!. سكتّ وهو يصرخ: توضأ وصل عليك لعنة الله!.
– توضأت وأطلت، فصاح بي: ياخبير اخرج بسرعة!، قلت له أنا جائع!، صاح بقوة راكلاً الباب بهستيريا: اخرج يا كلب، ياشرموط!، حاولت تهدئته!، سأخرج، سأخرج!، فتحت الباب فسحبني مرة أخرى، وقفت على باب الغرفة وتمنعت: لن أدخل حتى تذكر سبب اعتقالي ؟!، دفعني مرة أخرى إلى الداخل وأوصد الباب.. ضربت جدران الغرفة بقبضتي، يا إلهي، أنا جائع وخائف، صليت كثيراً، ودعوت الله أن يمنحني الصبر والجَـلد لمواجهة الأيام السوداء.
– بعد ساعات من الصراع مع الجوع والقلق دخل «أبو مراد» ببعض الطعام، ياخبير، قم تغدا!.، حملت جسدي المنهك، افترشت الأرض، ماهذا ؟ عصيدة بلون الصدأ بلا حساء، رائحة جوارب قديمة تفوح من طبيخ متسخ بداخل كيس أسود، وقنينة ماء.. لا أريد، تناولها أنت!.
– طز فيك، وبعدين ترجع تشغلنا أنك جائع.
– لي الله!
– لك الله!، لو الله معك أنه نصركم علينا.
– لقد انتصر هولاكو وهتلر، العبرة بالخواتيم.
أغلق الباب، نمت، وفي التاسعة مساءً، دخل بطعام جديد: هيا كُـل!، قدم لي كيساً أبيضاً فيه فولٌ، وخبز منزلي، وكيس حراري من القهوة، أكلت كالملهوف، وذهب صداع الرأس، شكرت «أبومراد» على (كرمه) فابتسم، كان أطيبهم، يتراجع عن قسوته، لم يكن حاقداً عليّ كما يبدو بخلاف بقية الأفراد الذين يحتلون المبنى الرياضي، شعرت أنه يتصنع القسوة، ليثبت جدارته في عمله، طلبت منه قاتاً!، ضحك القصير وأغلق الباب بقوة.
– غرفة السجن باردة وضيقة، للجدار المقابل للباب الخشبي نافذة تطل على فناء المبنى، فتحتها، جلست أتأمل بهدوء إلى الخارج، والكهرباء مطفأة كعادتها، و»أبومراد» يطوف حول المبنى للتأكد من عدم وجود خلايا مقاومة تستهدفهم، وقد أشيع قبل أيام أن مجموعة ممن يصفونهم بـ»الدواعش» حاولوا تفجير المبنى، وقبضت عليهم اللجان الشعبية التابعة للحوثيين، لم ينتبه «أبومراد» لوجودي في النافذة، كان يتمتم، وفمه يملؤه القات، وعلى جبينه مصباح كهربائي يبدد العتمة، صرخت عليه، فانتفض كمن لدغته أفعى، وضحكت كثيراً، لم يجد إلا أن يبادلني الضحك مُعلقاً: أرعبتني!.
– حاولت أن أكون جيداً، قرأت بعض سور القرآن ورجوت الله أن يمنحني الأمان والطمأنينة، لم أتذكر أني نمت، أفقت على صوت يناديني: قم هيا!.
– إلى أين، ومن أنت، وجهك مألوف، كم الساعة الآن؟
– أجابني الرجل حليق اللحية: أنا أبو عبدالإله ؟!.
ما هذه الكُنى التعيسة، يستخدم «الحوثيون» ذلك لإخفاء أسمائهم الحقيقية، شأنهم كبقية الميليشيا الثورية التي تتورط في العمليات المسلحة منعاً لمحاولة استهداف بيوتهم انتقاماً من أعمالهم الإجرامية بحق المواطنين العُـزل.. كررت عبارتي.. إلى أين؟
– أجابني: إلى مكان آمن!، وغادر الغرفة وترك الباب مفتوحاً، تبعته، وفي بهو المبنى تبينت ملامح شبان كُـثر ملثمون كيلا أتعرف على أحدهم، شعرت بالرعب، وقلت في نفسي: إنها النهاية!.
– وضع أحدهم فوهة بندقيته الروسية في ظهري، ودفعني للمشي حافياً نحو سلالم المبنى الخارجي، هناك سيارتان في الانتظار، اعتلى الملثمون العربة المكشوفة، فيما صعدت إلى جوار السائق، وعلى يميني «أبو عبدالإله»، كان الوقت متأخراً جداً، وفي الطريق المؤدي إلى الشارع العام، تتوزع العديد من سيارات «النجدة» والأطقم الأمنية، كل ما اقتربنا من بداية أي شارع تضيء إحدى السيارات مصابيحها كإشارة لتأمين سير العملية، سألتهم: أين سنذهب؟!.
– اسكت!
– حاولت أن أكون لطيفاً : إذاً هدئ من سرعتك، أنت ترعبني!.
كان يسابق الريح وخلفنا سيارة أخرى مدججة بالمرافقين، وصلوا بي إلى مبنى إدارة المباحث الجنائية بالمدينة، تبادل «أبوعبدالإله» التحيات مع حراسة المبنى، فتح الباب، دخلنا، تطاير الملثمون، أنزلوني من سيارتهم، ومندوب الحوثيين يطلب ضابط المباحث تحرير استلام بي، وكتب على ورقة صغيرة «أوصل الأخ الشيخ نبيل الزيادي «أبو عبدالاله» مندوب أنصار الله في البحث الجنائي المذكور أعلاه، وهذا استلام بذلك – التوقيع: مقدم أحمد سعيد التام رئيس قسم حماية الأموال العامة.
– شعرت بغضب الحوثيين الملثمين لإفلاتي من قبضتهم بتلك السرعة، شاهدت عيونهم تلمع في عتمة الليل كمستذئبين، خشيت أن أتعرض للضرب المبرح، ولم أصدق عينيّ وأنا أراهم يغادرون المبنى ويتركونني وحيداً بين قبضة رجال الأمن، شعرت بالأمان، ورأيت حريتي تأتي إليّ، القانون سيأخذ طريقه إليهم، ويرغم الجميع على فك أسري، وحمايتي من سطوتهم ومعاقبتهم على إفزاع عائلتي واقتحام دكان أبي، وجري إلى سجونهم، سيلاحقهم العار قبل الجنود.. اتصل بي مدير المباحث الجنائية العقيد محمد الحدي على هاتف أحد الضباط المناوبين: قال ضاحكاً: ماهذا الزخم كله يا صديقي، لقد قلبت العالم فوق رؤوسنا»، ابتسمت ولم أعلق، واستطرد قائلاً: لاتقلق، أنت الآن في وجهي، ثم أغلق سماعته، إلا أن الأيام القادمة كشفت أنه بلا وجه!، وأن البزة الخضراء الداكنة التي تميز رجال الأمن عن غيرهم لا تجعلهم رجالاً، وإن حملوا على أكتافهم ألف نجمة وعلى صدورهم أوسمة البطولة والفخار، ولم أدرك أن اللحظة التي تدلت فيها حريتي، ابتعدت، وتدلت أصفاد دولة تخدم الميليشيا، قيدتني على ظهرها وغادرت، وتمددت الأربع والعشرون ساعة لتصبح أربعة وستين يوماً.
يتبع…..